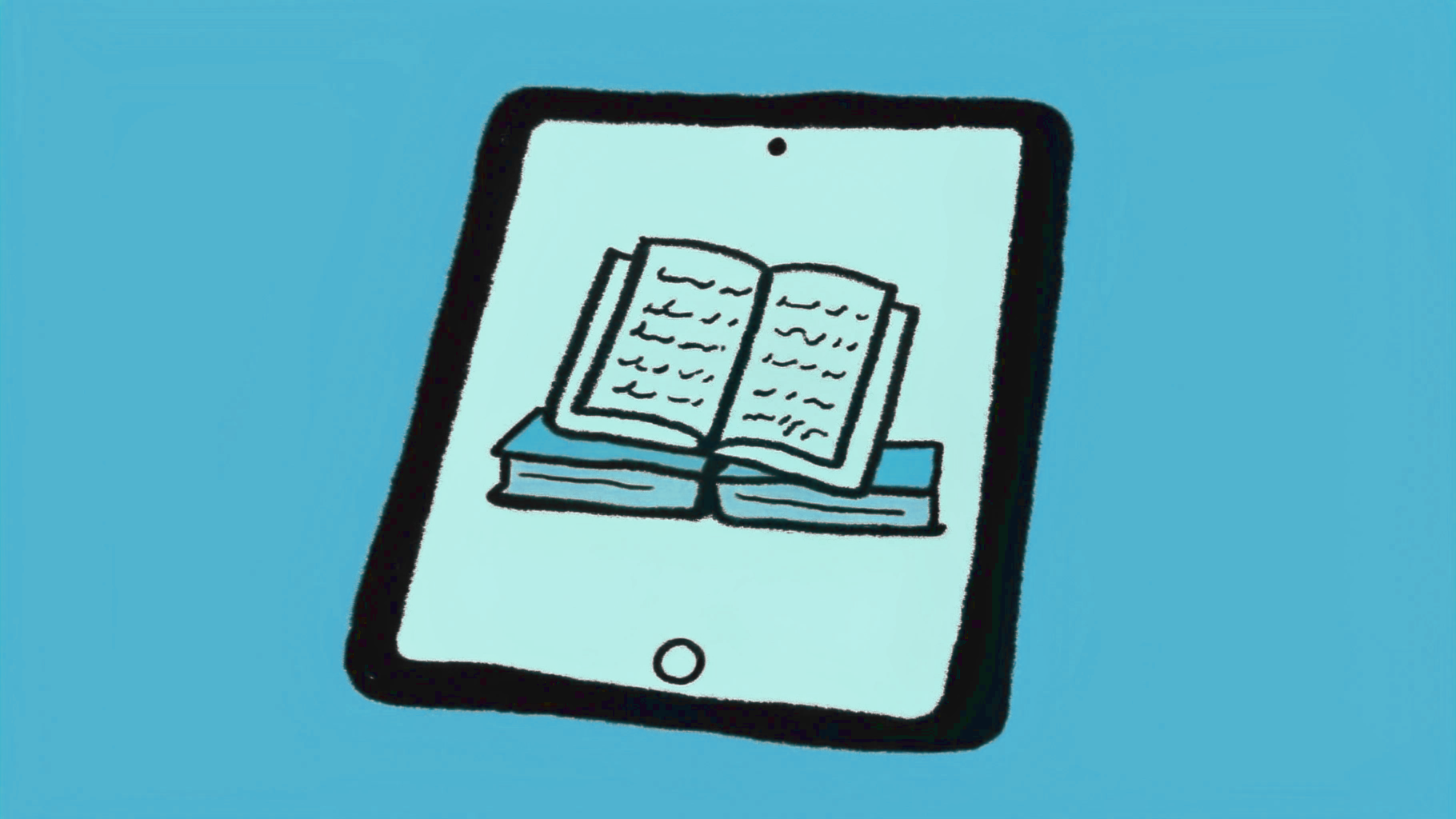نجحت مدرسة جريتنا بارك في لويزيانا في تعليم طلّابها القراءة بالإنجليزيّة والإسبانيّة باستخدام مدرّب ذكيّ. يراقب البرنامج قراءة الطالب، يحلّل أخطاءه، يشرح له تقطيع الكلمات وأصواتها. وفي مدارس مقاطعة سافانا-تشاثام، قرأ الطلّاب سبعةً وسبعين ألف دقيقة في شهرين فقط. هذه النجاحات تفتح الباب أمام سؤال مهمّ: هل يمكن تطوير نظام مماثل للغة العربيّة؟
بين التقنيّة والخصوصيّة اللغويّة
تزداد التحدّيات حين نتحدّث عن العربيّة. ففي حين يكفي الطالب الإنجليزيّ أن يعرف نطق الحروف الثلاثة m-a-p ليقرأ كلمة “map”، يحتاج قارئ العربيّة إلى نظام معقّد من الضوابط والحركات. وهذا التعقيد لا يقتصر على مجرّد النطق، بل يمتدّ إلى صلب المعنى ووظيفة الكلمة في الجملة.
يقول مارك إنجل، مطوّر برنامج “أميرا”: “نراقب قراءة الطالب لمدّة عشر دقائق، تمامًا كما يفعل المعلّم الجيّد”. لكنّ المعلّم العربيّ يراقب أكثر من مجرّد نطق الحروف. فكلمة “عَلِمَ” تختلف عن “عُلِمَ”، والفرق ليس في النطق فحسب، بل في تحديد الفاعل، وفهم هل الفعل مبنيّ للمعلوم أم للمجهول.
تحدّيات النظام الذكيّ في تعليم العربيّة
في مدرسة جريتنا بارك، يساعد النظام الذكيّ الطلّاب في تعلّم لغتين: الإنجليزيّة والإسبانيّة. وعندما تتوقّف الطالبة جاكلين عند كلمة صعبة، يظهر النظام صناديق وكرات ملوّنة تمثّل أجزاء الكلمة. لكنّ تعليم العربيّة يحتاج إلى ما هو أعمق من مجرّد تقطيع الكلمات.
يحتاج النظام الذكيّ للعربيّة إلى فهم العلاقة المعقّدة بين نظام الحركات والمعنى، وكيف تؤثر بنية الكلمة في وظيفتها داخل الجملة. عليه أن يدرك السياق النحويّ للجملة كاملة، وأن يفهم العلاقة الوثيقة بين الإعراب والمعنى. كل هذه العناصر تعمل معًا في نسيج واحد لا يمكن تفكيك مكوّناته بسهولة.
أخذت مدارس سافانا-تشاثام خطوة حكيمة حين بدأت بثلاث مدارس فقط، ثمّ توسّعت إلى أربع وثلاثين مدرسة بعد نجاح التجربة. وربّما نحتاج في العربيّة إلى مثل هذا التدرّج، مع التركيز على فهم خصوصيّة كل مرحلة وتحدّياتها.
ما وراء النطق: فهم طبقات المعنى
يشير الدكتور ماثيو بيرنز من جامعة ميسوري إلى أنّ “تقييم فهم القراءة ما زال سطحيًّا”. في العربيّة، يصبح هذا التحدّي أعمق. فقراءة نصّ غير مشكّل ليست مجرّد اختبار للنطق، بل هي عمليّة معقّدة تتطلّب فهمًا عميقًا للسياق العامّ للنصّ، ومعرفة بالقواعد النحويّة وكيفيّة تطبيقها، مع القدرة على توقّع الحركات المناسبة وإدراك العلاقات المتشابكة بين أجزاء الجملة.
يقيس برنامج “أميرا” قدرة الطفل على تسمية الحروف ونطق الكلمات وفهم النصّ. أمّا في العربيّة، فنحتاج إلى قياس قدرة المتعلّم على ضبط أواخر الكلمات، وفهم التغيّرات في بنية الكلمة ودلالاتها، وإدراك العلاقات النحويّة في الجملة، والتمييز بين الأساليب اللغويّة المختلفة. كل هذه المهارات تعمل معًا في منظومة متكاملة.
نحو مستقبل التعليم العربيّ الذكيّ
تتطوّر تقنيّات الذكاء الاصطناعيّ في تعليم القراءة باضطراد. ومع أنّ التجارب العالميّة مشجّعة، فإنّ تطوير نظام للعربيّة لم يزل أمامه الكثير. وكما كلّ حاجة سبق للتقنية أن تصدّت إلى تلبيتها، وكلّ مشكلة حلّتها التقنية، فإنّ البداية تكون بإدراك المشكلة وتناولها بالكتابة والبحث، والتوعية بشأنها.
هكذا قد ننجح في لفت انتباه المستثمرين والمطوّرين إلى هذه الحاجة التي تعد من يسدّها بمكاسب عظيمة. وأيًّا يكن من يتصدّى لتلبيتها فإنّ عليه أن يتشارك مع المعلّمين والباحثين والطلبة، لتوزين معادلة الحلّ بدقّة من جميع أطرافها، فلم تزل برامج الذكاء الاصطناعيّ تعمل بطريقة التفريغ النصّي ثمّ معالجة النصّ المفرّغ، ولذلك فهي لا تفهم مركبّات لغويّة حسّاسة مثل النبرة والوقفات اللغوية الدقيقة.
لذلك لا بدّ للشراكة مع المدارس والمعلّمين والطلبة وبالآتي الأهل، هكذا يمكن للباحثين تحديد الأسلوب الأفضل الذي يتّكئ على أفضل ما يمكن الآلة تقديمه: التكرار والثباتية، والبناء عليه بالاعتماد على الإبداع البشريّ الذي يتمثّل في تغذية المعلّمين المبدعين للنظام بالسيناريوهات المعهودة وكيفيّة التعامل معها.
نظرة إلى المستقبل
الحلّ قد يكمن في تطوير نظام متكامل يبدأ من التعرّف على الحروف وأشكالها، ثمّ يتعمّق في فهم نظام الحركات وتأثيرها، وصولًا إلى إدراك العلاقات النحويّة وفهم السياق والمعنى العامّ. لكنّ التحدّي الأكبر يظلّ في كيفيّة جعل هذه المستويات تعمل معًا بسلاسة، تمامًا كما تعمل في عقل القارئ العربيّ الماهر.
نحن نقف اليوم عند مفترق طرق في تعليم اللغة العربيّة. التقنيّات موجودة، والتجارب العالميّة مشجّعة، والحاجة ملحّة، واللغات تتنافس على ألسنة أبنائنا وعقولهم. النجاح الحقيقيّ سيكون في تطوير نظام يفهم حقًّا خصوصيّة العربيّة، ويتعامل معها لا كمجرّد لغة أخرى، بل كنظام فريد له منطقه وجماله وتحدّياته الخاصّة.